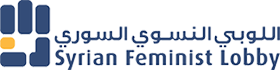بداية، أتقدم بعميق الشكر والامتنان لمؤسسة هاينرش بول ولكامل فريقها في برلين وفي مكتب بيروت على منحي هذه الجائزة، التي اعتبرها تكريماً لكل النساء السوريات، وعلى كل سياساتهم وبرامجهم الداعمة لحقوق الإنسان وكل القضايا العادلة.
الصديقات والأصدقاء،
بعد أيام قليلة من إعلان قرار لجنة التحكيم منحي الجائزة، تواصلت معي صديقتي أمل السلامات من إنطاكية، لتهنئني وتقول لي: “سعادتنا بهذه الجائزة لا تقل عن سعادتك! لقد حفزّت فينا الأمل… هناك من لازال يهتم لقضيتنا”.
تحمل صديقتي أمل/Amal إجازة في علم الاجتماع، وقد عملت في دمشق لسنوات طويلة كمرشدة اجتماعية في المدارس الثانوية، انحازت للثورة السورية وشاركت بها من أجل الحرية والمواطنة وسيادة القانون. اعتقل زوجها في آب 2013 وما يزال مختف قسرياً. ناضلت أمل من أجل العدالة في سوريا وللكشف عن مصير زوجها الصحفي جهاد محمد فتعرضت للملاحقة الأمنية، ما اضطرها للنزوح وحدها والتنقل في أماكن ومخيمات متعددة داخل سوريا قبل أن تصل إلى أنطاكية في تركيا، حيث سكنت في غرفة صغيرة تطل على شجرة زيتون ودالية عنب وشجرتي ورد جوري كما تقول. واستمرت بالعمل على قضية الاختفاء القسري ودعم الناجيات والناجين من العنف الجنسي.
استطاعت أمل النجاة بحياتها بصعوبة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط هذا العام، لكنها تعيش صدمة الفقد من جديد، بعد أن خسرت الكثير ممن حولها من صديقات وأصدقاء وجيران، أصبحوا بمثابة عائلة جديدة لها هناك. هُجرت أمل من جديد، واضطرت إلى ترك غرفتها الصغيرة التي تدمّرت مع شجرة الزيتون ودالية العنب وشجرتي الورد الجوري التي دفنت تحت الأنقاض، فيما تقيم الآن بضيافة صديقة لها في أنقرة، ولا تعرف ما الذي ستحمله لها الأيام القادمة. أمل التي طالما كانت مصدر قوة وإلهام لي ولكل من حولها، لم تعد بخير اليوم، والقادم مجهول تماماً. وبالمناسبة اسم أمل يعني بالعربية “الأمل/ Hope”، ولطالما قلت لها: أنت اسم على مسمى. لكن لا أمل ولا الأمل اليوم بخير، لأننا جميعا محاصرون بنكباتنا المستمرة كسوريين.
قصة أمل هي قصة الكثير من أصدقائي وصديقاتي الذين تعرّضوا لشتى أنواع الانتهاكات وما زالوا. على مدى السنوات الماضية قابلت مئات الناجين من النساء والرجال الذين تعرّضوا للاعتقال والتعذيب والتهجير، وبعضهم تعرّض للعنف الجنسي. غالبية هؤلاء النساء كنّ قد اُقتلعن من مدنِهنّ وقراهنّ مع مئات الآلاف من السوريات والسوريين ممّن تمّ تهجيرهم قسرياً الى مناطق شمال غرب سوريا، الكثيرات منهن وحيدات مع أطفالهن في مواجهة القصف الروسي المستمر وانتهاكات قوى الأمر الواقع على الأرض، عنف من الأرض والسماء، في ظل ضعف وهشاشة كل أدوات المقاومة لديهن، واليوم يضرب الزلزال استقرارهنّ الهشّ، ويشرّدهن مرة أخرى، تشرّد وراء تشرّد. معظمنا يعرف بأن مناطق شمال غرب سوريا تركت وحيدة في مواجهة الكارثة لخمسة أيام متواصلة، بإمكانيات متواضعة جداً، ومعابر مغلقة أمام فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية، بانتظار إذن رأس السلطة في دمشق، الأسد نفسه، الذي هجّرهم وقصفهم بالكيماوي، لكي تفتح المعابر بعد تلاشي أمل عائلات بأكملها في العثور على أحبّتهم أحياءَ تحت الأنقاض، ولم يعد لا الاعتذار ولا الأسف مجديين.
الصديقات والأصدقاء،
هل لكم أن تتخيلوا أن 90% من الشعب السوري لم يعرفوا إلا عائلة الأسد حاكمة للجمهورية التي ورثها الابن عن أبيه؟ هل لكم أن تتخيلوا؟
أنا شخصياً لم أعرف غيرها! فقد ولدت في العام 1970، ذات العام الذي استولى فيه حافظ الأسد على السلطة التي أورثها بدورهِ لابنهِ في عام 2000. ثلاثٍ وخمسون عاماً تحولت فيها سوريا إلى معتقلٍ كبير. شخصياً، اختبرت معنى الخوف من التغييب والتعذيب والاعتقال منذ طفولتي، وراقبت، كما كل أبناء وبنات جيلي، كيف استخدم النظام الاعتقال كأداة أساسية للقمع والإخضاع، وكيف تحولت سوريا إلى مملكة للصمت منذ ارتكاب مجزرتي تدمر وحماة وغيرها. وعندما قرر السوريون كسّرَ صمتِهم، وهتفوا للكرامة والحرية عام 2011 تفوّق الأسد الابن على أبيه، وقام بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقِهم والتي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
منذ الأيام الأولى للثورة، والتي تصادف ذكراها السنوية الثانية عشر هذا الشهر، بذل السوريون والسوريات جهوداً جبارة من أجل توثيق هذه الجرائم، منهم من قتل، ومنهم من اختطف واختفى، مثل صديقتيّ العزيزتين رزان زيتونة وسميرة الخليل، ومنهم من غامر بحياته ليخرج ما نجح في جمعه من أدلة موثقة خارج البلاد، ليقوم بتقديمها للمجتمع الدولي من أجل محاسبة المرتكبين، كما فعل المصور الشجاع الملقب بسيزر، لكن على الرغم من كل هذه الجهود والتضحيات، وما وثّقته المنظمات السورية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية ظل باب محكمة الجنايات الدولية مغلقاً في وجه الضحايا رغم المحاولات المتكررة، بسبب الفيتو الروسي والصيني.
في مثل هذا الشهر من العام 2017 وفي الفعالية التي رعتها هينرش بول في هذه القاعة بالذات، وبعد الاستماع الى زميلي فولفغانغ كاليك، ولم أكن أعرفه بعد، وهو يشرح عن الولاية القضائية العالمية وعن الدعوى الجنائية التي قدمت الى المدعي العام الفيدرالي الألماني والاستماع الى الناجين والنقاش الذي دار على هذه المنصة، أحسست بشعور غريب، فعلى الرغم من ألم وصعوبة ماسمعته من الناجين حينها إلا أنني أحسست بسعادة صاحبت هذا الألم، فقد أضيئت شعلة أمل على طريق العدالة لسوريا. وقد فتح باب للاعتراف بالضحايا والمحن التي عاشوها، فتح باب للحقيقة والانصاف ومحاربة الافلات من العقاب.
بعد أسابيع قليلة من ذلك الحدث، جمعني لقاء في الخارجية الالمانية مع عدد من منظمات المجتمع المدني الألمانية، التي تعمل على الشأن السوري، لألتقي مع زميلتي ليلي الكاثر التي عرضت عليّ التقدم للعمل معها في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، وكان هذا من حسن حظي حقاً. مازالت أذكر كل تفاصيل مقابلة العمل الأولى مع زميلي باتريك كروكر، وأذكر ابتسامته حين قلت له: يسعدني أن أعمل معكم ولو تطوعاً، لأنني أعمل من أجل قضيتي!
قضيتي هذه ليست وليدة عملي هنا، هي قضية اخترتها منذ وعيت الظلم ومصادره المتعدّدة التي تتقاطع لإخضاع النساء.
في بداية حياتي العملية، من خلال قربي من المئات من النساء العاملات، اكتشفت فداحة العنف والتمييز الذي تعاني منه النساء في بلدي سواء على المستوى الاجتماعي أو القانوني أو السياسي أو الثقافي وانعكاساته على حياتهن اليومية، ومن ثم أدركت أن هذا العنف والتمييز ما هو إلا نتيجة حتمية للاستبداد السياسي وتواطؤ قوى أخرى تجمعها المصالح معه، وذلك من خلال تحييد النساء ووضعهن في مراكز أدنى بدرجات من مراكز الرجال، وبالتالي ينجح الاستبداد في تحييد نصف الشعب السوري مستخدماً أدواته من الحلفاء الدينيين والمجتمعين في طريقه لإخضاع المجتمع بكامله.
هذا ما حصل تماماً بعد انطلاقة الثورة، كانت مشاركة النساء مدهشة، ربما لأنهنّ رأين في تلك اللحظة التاريخية فرصة للحصول على حقوقهن، والخلاصِ من التمييزِ والقهرِ والتهميش. لكن النظام استثمر في العقلية الذكورية التي كرّسها الاستبداد في المجتمع، والتي تربط شرف العائلة والمجتمع بأجسادِ النساء. فقامَ باعتقال النساءِ الناشطاتِ والمشاركاتِ بالثورة، وكذلك زوجاتِ وبناتِ وأخواتِ الثائرين ضدّه للانتقام منهم، وهو على يقين مما ستواجهه الناجية من المعتقل من الوصم المجتمعي والنبذ، والتخلّي بسبب الافتراض المسبق بأنها تعرّضت للاغتصاب، وبذلك نجح مجدّداً في تفتيت المجتمع وإضعافه وتحييد نصفه الثائر من جديد.
لايماني بان العدالة يجب أن تكون شاملة لا تقصي أحداً، وإيماني بحق الناجيات في الوصول إلى سبل الإنصاف، ساهمت بالعمل مع زميلاتي وزملائي على مسارات عدة وبالتوازي:
على الصعيد الاجتماعي، عملنا على الإضاءة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجهها الناجيات من الاعتقال والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، وذلك عبر العديد من الفعاليات والأنشطة، وتمّ إطلاق حملة “الطريق إلى العدالة” من قبل مجموعة من المنظمات النسوية السورية، من أجل إيجاد سُبل لإنصاف الناجيات والتخفيف من معاناتهن.
في خطٍ موازٍ عملنا على مناصرة قضية العنف الجنسي والجنساني، وحثّ المنظمات الدولية والداعمين لتقديم الخدمات الصحية والنفسية للناجيات عبر مشاريع دعم طويلة الأمد.
على المستوى القانوني، وبعد سنوات من التحقيق في الجرائم، وبالشراكة مع شبكة المرأة السورية (Syrian Women’s Network) ومنظمة أورونامو (Urnammu) ، وبالنيابة عن سبعة من الناجيات والناجين، قدمنا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، شكوى جنائية الى المدعي العام الفيدرالي الألماني، نطالب فيها التحقيق في جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي المرتكبة في مراكز الاعتقال التابعة للمخابرات الجوية ومكتب الأمن الوطني ومايزال التحقيق حولها مستمراً.
كما قدم المحاميان باتريك كروكر وسيباستيان شارمر، شريكا مركزنا، طلباً الى محكمة كوبلنز باسم مجموعة من الشاهدات والشهود، من أجل الاعتراف بالعنف الجنسي كجريمة ضد الانسانية وليس كانتهاكات في حوادث فردية كما ورد في لائحة الاتهام. وقد تضمن الطلب أكثر من مئة دليل على هذه الجرائم ومنهجية ارتكابها.
وأثناء محاكمة كوبلنز التي استمرت على مدى 21 شهراً، استمعت هيئة المحكمة كما استمع العالم، من خلال اهتمام الصحافة، إلى الشهادات المروعة التي قدمتها ناجيات شجاعات وناجين شجعان، حول ما تعرضن وتعرضوا له في معتقلات الأسد. وقد صرّح العديد منهن/م للصحافة وفي بياناتهم الختامية للمحكمة بأن ما دفعهم للإصرار على المشاركة في المحاكمة، على الرغم من الخوف من انتقام النظام والتبعات الصحية والنفسية للنبش في الذاكرة المؤلمة، هو الإحساس بالمسؤولية والواجب تجاه من تركوهم هناك في أقبية الموت، وإظهار الحقيقة للعالم أجمع عبر قضاء لا يشك بنزاهته.
في كانون الثاني من العام الماضي، أصدرت المحكمة حكمها التاريخي، وتمّ الاعتراف بجرائم العنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية، إلى جانب جرائم القتل والتعذيب والحرمان الجسيم من الحرية، الحكم الذي اعترف بحقوق الضحايا وانتصر للحقيقة في مواجهة سردية نظام الأسد المجرم، الذي ينكر إنكاراً تاماً ما تمّ ويتم ارتكابه من انتهاكات جسيمة في معتقلاته الرهيبة.
لم أحضر شخصياً داخل قاعة المحكمة حين صدر الحكم في محكمة كوبلنز، كنت قد قررتُ أنا وبعض زميلاتي أن يبقى بعضنا خارج قاعة المحكمة كي نتيح للحضور من ذوي الضحايا أن يأخذوا أماكننا. مكاني خارج المحكمة يومذاك سمح لي أن أرى الوجوه المفعمة بالأمل والفرح وهي تخرج من باب المحكمة بعد إصدار الحكم، وأستمع إلى وصفهم لما جرى. قالت لي واحدة من المدعيات الشجاعات، وهي تكاد تطير فرحاً، بأن المحكمة اعترفت بالعنف الجنسي كجريمة ضد الانسانية، وبأن المحكمة قد عادت إلى سنوات بعيدة من تاريخ سورية وعدّدت المجازر التي ارتكبها الأسد الأب في نصّ الحكم، وهذا يعني أنها عادت إلى الانتهاكات التي أسست للديكتاتورية على مدى عقود حكمها، وهو ما وصفته الشاهدة بالإنصاف، ليس لها وحدها، بل لكل ضحايا الاستبداد.
لقد أحيا حكم كوبلنز الأمل بالعدالة لدى الكثير من السوريين والسوريات، ومنهم مَن تواصل معي بعدها من أجل الخطوات التالية آملين بأن محكمة كوبلنز قد وضعت حجر الأساس في طريق العدالة الطويل لتغير واقع السوريين المظلم، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظلم على مدى سنوات في ظل تراخي المجتمع الدولي عن إيجاد حلّ عادل ينهي مأساتهم الإنسانية.
اليوم يحتاج السوريون والسوريات الدعم والمساندة والتضامن والتعاطف أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد كارثة الزلزال. يحتاجون إلى حل جذري لكل مآسيهم، عبر حل سياسي عادل، وفق القرارات الدولية، حل يحقق الانتقال الديمقراطي الذي دفعوا الكثير من التضحيات من أجله، ويحتاجون إلى ضمانات بأن تضحياتهم لن تذهب سدى.
أكثر ما نخشاه اليوم هو التطبيع مع النظام أو إعادة تأهليه وتجاهل إرادة الشعب السوري وتضحياته. وهذا إن حصل سيكون انتهاكاً صارخاً لكل حقوق الانسان وعاراً على الانسانية جمعاء وعلى الدول الديمقراطية بالذات، التي مازال الشعب السوري يأمل منها أن تساعده على الخلاص مثلما يأمل الشعبين الأوكراني والإيراني في حربهما ونضالهما من أجل الديمقراطية والحياة الكريمة. فلا تخذلوا هذه الشعوب المنكوبة لأن فقدان الأمل لن يقود إلا إلى العدمية والرغبة في الانتقام.
بالنسبة لي لن أفقد الأمل.
الصديقات والاصدقاء،
كثيرا ما سئلت من قبل الصحفيات والصحفيين: من أين تستمدين الطاقة للقيام بهذا العمل المجهد؟ أجيب: أستمدها من السوريات والسوريين الذين مازالوا رغم كل ما حل بهنّ وبهم من كوارث مصرّين على العمل وعلى المقاومة وعلى تحقيق حلمهم. أستمدّ الطاقة من النساء السوريات العظيمات الناجيات من الاعتقال والعنف الجنسي، واللواتي مازلن يناضلن من أجل العدالة والحرية والمساواة، ومن أمهات ونساء المختفين قسراً اللواتي أبهرن العالم بصلابتهن وبإصرارهن على إسماع أصواتهن ومعرفة مصير أحبتهن. استمدها من تضامن السوريات والسوريين مع بعضهم في كل مكان في سوريا بعد كارثة الزلزال، بعيداً عن الحكومات وعن قوى الأمر الواقع وعن كل أجندات الدول، وهو خير مثال على أصالة الشعب السوري وعلى وجود أمل كبير بمستقبل أفضل إذا توفرت له الظروف المناسبة.
أن أبقى قيّد الأمل ليس خياراً بالنسبة لي، بل هو الطريق الوحيد الذي أملكه، مثل العديد من السوريات والسوريين الذين وعلى الرغم من كل هذا اللايقين متمسكون بعدالة قضيتهم، ومستمرون في خوض الطريق الذي بدأناه من أجل إنسانيتنا وكرامتنا ووفاءً لأحبتنا الذين قضوا وللأجيال القادمة. نعرف أن طريق العدالة صعب وشائك لكن لا خيار لنا سواه.
أخيراً: كل الشكر مرة أخرى إلى مؤسسة هاينرش بول، وإلى والدي الغالي الذي علمني معنى الالتزام، وإلى عائلتي و كل صديقاتي وزميلاتي النسويات على تضامنهن ودعمهن الدائم وفي أشد الاوقات.
الشكر العميق إلى كل زميلاتي وزملائي في مركز ال ECCHE الذين آمنوا بالقضية السورية وقاموا بالكثير من العمل المخلص من أجل دعم حقنا بالعدالة، وشكر خاص الى زميلي أندرياس شولر على اشرافه و دعمه الدائم.
والشكر موصول إلى كل من ساند ويساند قضيتنا السورية العادلة.