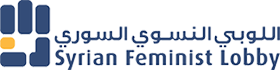د. مية الرحبي
مساواة مركز دراسات المراة
ليست وحدها آية، بل ملايين النساء السوريات كن ضحايا العنف بكل أشكاله. هل هنالك امرأة سورية تستطيع القول أنها لم تكن ضحية شكل من أشكال العنف، أو تعرضت لكل أشكاله، يوما ما؟
يتجذر العنف ضد المرأة عميقًا داخل المجتمعات الإنسانية كافة، وإن اختلفت أشكاله وأنماطه، فرغم التقدم القانوني الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال بقي الموضوع اشكاليًا مسكوتًا عنه، تتحمل الضحية غالبًا عبأه.
في مجتمعاتنا العربية تمت شرعنة العنف ضد المرأة بقوانين جائرة، تتعاضد مع أعراف اجتماعية وتفسيرات دينية تجعل من المرأة الضحية موضوعًا لعنف أكبر يقع عليها في حال تجرأت وأعلنت عما تعرضت له من عنف.
في سوريا وفي الزمن الذي سمي زمن السلم، رغم ما كان يتم فيه من قمع واضطهاد مسكوت عنه، عانى الرجال من عنف الدولة الذي تجلى في إذلالهم وقهرهم وإفقارهم وإعتقالهم وتعذيبهم، وعانت النساء ذلك كلَّه مضافًا إليه عنف أسري ومجتمعي واقتصادي وقانوني.
لايوجد في تاريخ سوريا الحديث أي إحصاء أو دراسة أو بحث قامت به جهة رسمية عن هذا الموضوع، لكن مشاهداتنا المجتمعية تخبرنا بما لا يدع مجالاً للشك أن العنف ضد المرأة كان ظاهرة متفشية في المجتمع مشرعنة قانونيا، ومغطاة بلبوس ديني، تفتقت عنه تفسيرات دينية نابعة من أذهان فقهاء ورجال دين، لا زالوا يطلون علينا في برامج تلفزيونية، حاملين أفكاراً من قرون مضت، يغذون عنف متأصل لدى رجال ربّوا في مجتمع ذكوري مبني على التسلط والهيمنة والسيطرة من قبل كل من يمتلك سلطة سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية، جعلت الرجال الأقوياء في أعلى السلم الاجتماعي، يتلذذون بممارسة العنف على كل الفئات المهمشة الضعيفة في المجتمع من رجال ونساء وأطفال.
الرجل، في مجتمعنا المحكوم بأنظمة استبدادية، هو السيد القوام، يمارس جبروته وديكتاتوريته على من هو أضعف منه ولو كان فرد واحد أو أسرة صغيرة، فهو لايشعر بقيمته ووجوده إلا بتسلطه هذا.
تتعاضد الدولة والمجتمع والأسرة في بلادنا لممارسة جميع أشكال العنف ضد المرأة، رغم أن هذه الجهات هي الجهات الموكل إليها افتراضياً حماية ورعاية المرأة، وكل فرد آخر في المجتمع. وتمارس هذه الجهات مجتمعة كل أشكال العنف القائم على أساس النوع أو الجنس الذي عرفها «الإعلان العالمي للقضاء على العنف المسلط على النساء»، المنبثق عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب التوصية عدد 48/104 المؤرخة في 18 كانون الأول 1993، بأنه أي فعل ينتج عنه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
بداية الألفية الحالية حاولنا كمدافعات عن حقوق المرأة تنظيم أنفسنا في تجمعات صغيرة، رفضت الحكومة آنذاك ترخيصها، بل تمت ملاحقتنا أمنياً بسبب نشاطنا في المجال النسوي، ورغم ذلك استطعنا تحقيق بعض الانجازات الصغيرة، أحدها كان استبيان عن العنف الأسري أجريتُ عليه دراسة لتحري انتشار ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السوري (ولنا الفخر أن تلك هي الدراسة الوحيدة التي تمت في سوريا في هذا المجال)، على 500 عينة عشوائية لنساء من مختلف مناطق سوريا ومختلف الشرائح المجتمعية المتباينة اقتصادياً وثقافياً وعرقياً ودينياً، ويمكننا تلخيص نتائجه كما يلي:
- 80% من الفتيات تعرضن لعنف معنوي من قبل أسرهن في الطفولة.
- 80% من الفتيات تعرضن لعنف جسدي من قبل أسرهن في الطفولة.
- 14% من النساء تعرضن للتحرش من قبل المحارم في الطفولة.
- منع الأهل 27% من الفتيات من متابعة التعليم.
- 87 % من الفتيات قمن بالأعمال المنزلية لدى أسرهن دون أخوتهن الذكور.
- 59% من النساء تعرضن للإهمال من قبل الأسرة.
- 77% كان أهلهن يمنعوهن من الخروج من المنزل.
- 71% من النساء منعن من قبل الأهل من الخروج للتسلية والقيام بنشاطات اجتماعية.
- 38% حرمن من الإرث.
- 45% يضربن من قبل أزواجهن.
- 63% يتعرضن لعنف معنوي من قبل أزواجهن.
- 39% من المتزوجات يجبرها زوجها دائما أو أحيانا على ممارسة الجنس عندما لا تكون راغبة بذلك.
- 62% شكون من إهمال أزواجهن
- 50% يمنعهن أزواجهن من الخروج من المنزل.
- 55% منعهن أزواجهن من الخروج للتسلية و النشاطات الاجتماعية.
العنف القانوني يبدأ من الدستور الذي تنص المادة الثالثة منه على أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، ما يفسح في المجال لقوانين أحوال شخصية مميزة ضد المرأة، كتبت بأيدي رجال ذكوريين، مؤيدة بتفسيرات فقهية ذكورية بامتياز. إذ تنص نفس المادة على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. مع العلم أن قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية تحوي مواد مميزة ضد المرأة أيضاً، ما يخلق تمييزاً بين الرجال والنساء، وبين النساء أنفسهن في الوطن الواحد، بما يخالف المادة 33 من الدستور التي تقر المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وهنا لابد من أن ننوه بأن التعديل الأخير، الذي طال قانون الأحوال الشخصية العام في العام الماضي، لم يحو أي تعديلات جوهرية بل اقتصر على “تجميل” بعض المواد.
ولا يقتصر التمييز القانوني ضد المرأة على قوانين الأحوال الشخصية العديدة في سوريا، بل يمتد إلى قانون الجنسية الذي يحرم النساء وأطفالهن من منح جنسية الأم لطفلها، ومواد عديدة من قانون العقوبات نذكر منها شرعنة الاغتصاب الزوجي، وتخفيف العقوبة على المغتصب الذي يتزوج ممن اغتصبها، ومواد تخفف العقوبة على مرتكب الجريمة باسم الشرف حتى بعد إلغاء مادة العذر المخفف في تلك الجرائم رقم 548. إضافة لذلك لا تتمتع المواطنة السورية بصحيفة مدنية مستقلة بل تبقى دوماً ملحقة بخانة أهلها أو زوجها، ما يشكل اضطهاداً مادياً ومعنوياً ضد النساء عامة، والمطلقات والأرامل منهن على وجه الخصوص.
اقتصادياً يبدأ العنف ضد المرأة من إقرار حصتها المجتزأة في القانون، والذي لا يجرؤ النظام الاستبدادي على تغييره حتى لو رغب بذلك، وهو غير راغب، محاباة لفئة رجال الدين الذين يقفون في صفة مبررين جرائمه ضد شعبه، في تعاضد تاريخي بين الاستبداد السياسي والذكوري والديني، وحتى هذه الحصة تُحرم الكثير من النساء منها، وخاصة في الأرياف حيث تقوى الأعراف على الدين والقانون. وللمفارقة، يحرم القانون النساء من التساوي في الإرث، رغم إقراره مواد قانونية تخالف الحدود في الإسلام دون اعتراض من رجال الدين، كما أن هنالك مادية قانونية تلزم الولد ذكراً كان أم أنثى بنفقة والديه الفقراء (المادة 158)، رغم أن مبدأ عدم التساوي بالإرث قام شرعياً على أساس أن الذكر يحصل على الحصة الأكبر لأنه كان ملزماً مجتمعياً بالنفقة على والدية وإخواته، ذلك الواقع الذي لم يعد قائماً حالياً.
ويتفاقم العنف الاقتصادي ضد المرأة بالواقع الاجتماعي والقانوني الذي يحرم المرأة من نتاج عملها لدى الأسرة وخاصة العاملات الزراعيات (المادة 140 من قانون العمل الموحد)، يضاف إلى ذلك سيف الطلاق التعسفي بإرادة منفردة من الرجل، المسلط على رقبة المرأة، ومبدأ القوامة، وإجبار الزوجة، قانونياً واجتماعياً، على تبعية زوجها في مكان الإقامة الذي يختاره هو، ما يجعل من حرية تصرفها بأموالها، وحريتها في اختيار عملها ونوعه ومكانه، المقرة قانونياً، كلاماً على الورق لاقيمة له على أرض الواقع، وبالتالي يضع المرأة بين خيارين أحلاهما مرّ، إما السكوت على العنف أو هدم أسرتها، وتحمل العواقب المجتمعية والقانونية عليها وعلى أولادها في ظل قوانين مجحفة بحق المرأة والأطفال في حال الطلاق، خاصة بالنسبة للمرأة التي لا تملك أيّ مكان أو وسيلة اقتصادية تمكنها من العيش حرة مستقلة بعده، وهو حال الغالبية العظمى من النساء السوريات غير المؤهلات للعمل خارج المنزل.
كل تلك العوامل مجتمعة تدفع النساء لتحمل كل أشكال العنف الواقع عليهن لعجزهن عن تغيير ظروف حيواتهن.
يضاف إلى ذلك كلّه، الضغوط المجتمعية التي تعيب على المرأة، بل تسمها بالعار في حال تجرأت وباحت بما تعرضت له من عنف، فالزوجة التي تتعرض لعنف من الزوج يجبرها أهلها على البقاء مع زوجها والصبر على العنف، وطالما سمعنا عن حوادث انتحار لنساء أجبرهن الأهل على العودة إلى الحياة الزوجية رغم معرفتهم بوحشية الزواج في التعامل مع ابنتهم. كذلك وصمة العار التي تصم من تتحدث عن تعرضها لعنف جنسي، وتدفع الأهل في بعض الأحيان إلى قتلها غسلاً للعار، وصمت العاملات على تحرش أرباب عملهن بهن، خوفاً من الفضيحة وحفاظاً على لقمة العيش، خاصة النساء المعيلات منهن. ولاننسى شرعنة المجتمع للعنف المعنوي من قبل الأهل والأزواج الذي يتضمن الشتم والاستهزاء والتحقير وكل صنوف العنف المعنوي الذي لايسمى أصلاً عنفاً، بل يصنف من طبيعة الأمور المعتادة التي لاتعيب الرجل ولا تؤذي المرأة. ولا يعتبر المجتمع إجبار الرجل زوجته على ممارسة الجنس عنفاً، ويشرعن رجال الدين والمواد القانونية ذلك.
يساهم رجال الدين في إلباس العنف ضد النساء لبوساً دينياً حتى يكاد يوضع في منزلة الفرائض، ففي القرن الواحد والعشرين يطل علينا رجل دين من على شاشة التلفزيون ليحاضر بنا أن الإسلام كرّم المرأة بضربها، عندما منع زوجها من ضربها ضرباً مبرحاً، فالمرأة بحاجة لتأديب والزوج مجبر على ضريها لتأديبها، ولكن لايجوز له أن يرفع العصا إلا بمقدار معين، ولا يجوز أن يكسر سناً أو يقلع عيناً…الخ، ويباح للزوج ضربها لإجبارها على العلاقة الجنسية، بل أنهم يبررون حتى تزويج الفتاة بعمر التاسعة، ومداعبة الرضيعة، بأحكام وفتاوى من اختراع عقولهم الذكورية المريضة.
يتضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي في أزمان الحروب، وتتعرض النساء لعنف يتمايز عن العنف الذي يقع على المدنيين كافة، وقد ألزمت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة بالمعاملة الإنسانية “دون أي تمييز ضار يقوم على أساس الجنس”.
من أشكال العنف المطبق على المرأة في زمن النزاعات المسلحة:
ـ القتل: تقتل النساء كما الرجال والأطفال والشيوخ والعجزة بواسطة الأسلحة الثقيلة، إلا أن انتشار الأسلحة الفردية زاد من حوادث قتل النساء بذريعة الشرف، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 28076 امرأة قتل منهن 83% بيد النظام السوري وحلفائه.
ـ الإعاقة: يتعرض الناجون من الموت لإصابات جسدية قد تسبب لهم إعاقة مدى الحياة، ولكن من المعروف أن تأثير الإعاقة اجتماعيًا على مستقبل المرأة أكبر من تأثيرها على الرجل، فالرجل الذي تعرض للإصابة يمكنه متابعة حياته على الصعيد الشخصي أو العامٍ، بينما تفقد المرأة كل فرصة مستقبلية في بناء مستقبل شخصي أو مهني إلا فيما ندر.
ـ صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية ومنها خدمات الصحة الإنجابية، ما يتسبب في مرض أو موت بعض النساء، خاصة في مناطق سيطرة المعارضة، نتيجة الحصار الذي طبق على مدن عدّة، أو استهداف المستشفيات من قبل النظام وحلفائه (حسب تقارير عدة منها تقرير لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا).
ـ النازحات: تعاني النازحات معاناة مضاعفة أثناء رحلة النزوح وفي المخيمات من خطر تعرضهن لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف والاستغلال الجنسيين، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي ينزحن وحيدات مع أطفالهن، كما يعانين، من سوء الوضع الاقتصادي نتيجة فقدان الأملاك وفقد المعيل. وقد صدر تقرير “الجنس مقابل الغذاء” يوثق ذلك في مراكز إيواء دمشق وريفها.
ـ اللاجئات: تعاني اللاجئات في دول الجوار من نفس معاناة النازحات يضاف إلى ذلك العمل في أعمال شاقة بأجور متدنية (العاملات الزراعيات في لبنان)، وصعوبة التنقل بسبب ضياع الأوراق الثبوتية، والتعرض للاستغلال الجنسي والتزويج المبكر. كما أن ملايين اللاجئين في دول اللجوء المجاورة غير مسجلين في مفوضية الأمم المتحة المعنية باللاجئين وبالتالي ليس لهم الحقوق المقرة أممياً للاجئين في بقية دول العالم.
ـ يتفاقم العنف الاقتصادي المطبق على النساء في فترات النزاع المسلح، ففقد المعيل لنساء لم يكن مؤهلات أصلا للعمل خارج المنزل وكسب الرزق يؤدي إلى أن تكون النساء عرضة لكافة أشكال الاستغلال، والعنف سواء بقين بانتظار المساعدات، أوعند خروجهن إلى سوق العمل.
ـ إن سياسة التغيير الديموغرافي الممنهج التي اتبعها النظام السوري وحلفائه، وبعض الفصائل المسلحة الأخرى، أثرت على النساء بشكل مضاعف، خاصة النساء اللاتي تمحورت حياتهن سابقاً في دائرة الأهل، دون تجارب حياتية سابقة تؤهلهن للتأقلم مع الأوضاع المستجدة.
ـ مارست داعش والفصائل الإسلامية المتطرفة ممارسات بشعة وارتكبت أشكال عنف وحشية لايصدق المرء أنها يمكن أن ترتكب في زمننا الحاضر، من سبي وبيع واغتصاب ورجم وجلد وتزويج بالإكراه، وتقييد في اللباس والحركة والتعليم والعمل.
ـ تتعرض النساء في فترات النزاعات المسلحة لعنف جنسي من تحرش واعتداء واغتصاب، وتستخدم القوى المتحاربة الاغتصاب كأداة حرب لإذلال الخصم، وكذلك التزويج القسري والاتجار والسبي والحمل القسري والاجهاض القسري. كما تتعرض النساء للتحرش الجنسي أثناء التفتيش والمداهمات والمرور بالحواجز. واستخدم الاغتصاب أيضاً كوسيلة تعذيب لبعض المعتقلات في بعض مراكز الاعتقال لدى النظام السوري، ولا يمكن الجزم إن كان ممنهجاً أم لا، بسبب امتناع الكثير من الناجيات عن الإفصاح عنه، لكن أشكالاً اخرى من العنف الجنسي طبقت على أغلب المعتقلات كالتحرش والتعرية أو التهديد بالاغتصاب.
ـ المعتقلات والتعذيب ومعاناة الناجيات: حسب إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان هنالك الآن 10363 معتقلة، 81% منهن لدى النظام، والباقي معتقلات لدى الفصائل المسلحة، وقد سجل مقتل 90 امرأة تحت التعذيب في سجون النظام. تتعرض المعتقلات لكافة أنواع العنف والممارسات الوحشية داخل المعتقلات إذ تطبق عليهن كافة أشكال التعذيب الجسدي المرعبة، والإذلال والإهانات المعنوية، إضافة إلى العنف الجنسي من تحرش واغتصاب، كما تتعرض المعتقلات في فترات الحمل والولادة إلى نقص الرعاية الصحية، واحتجاز أطفالهن معهن في ظروف غير إنسانية، أو انتزاع الأطفال منهن وإرسالهم إلى ملاجئ للأيتام، وحرمانهن من الزيارات وتوكيل محامٍ، وعدم محاكمتهن، أو تقديمهن إلى المحاكم الاستثنائية. وما يبعث على الأسى هو وصمة العار التي توصم بها الناجية من الاعتقال من قبل المجتمع، ففي حين يستقبل الناجي الرجل استقبال الأبطال بعد خروجه من المعتقل، تتعرض الناجيات إلى كافة أنواع العنف الأسري والمجتمعي الذي أدى لمقتل بعضهن على يد الأهل، أو هروب بعضهن من المحيط الأسري والمجتمعي وتعرضهن وحيدات لأشكال أخرى من العنف، إضافة إلى سكوتهن عن الانتهاكات التي وقعت عليهن داخل المعتقل، ما يؤدي إلى إفلات الجناة مستقبلاً من العقاب، وقد لاقت بعض المعتقلات اللاتي أدلين بشهاداتهن خاصة عن العنف الجنسي الذي تعرضن له داخل المعتقلات إلى نبذهن اجتماعيا وتهديدهن حتى من قبل زميلاتهن المعتقلات السابقات.
ـ تجنيد القاصرات، إذ عمدت بعض الفصائل الكردية المسلحة إلى تجنيد النساء قسرياً وحتى القاصرات منهن، وهنالك تقارير تتحدث عن التجنيد القسري أو تجنيد القاصرات، وهروب بعض الأسر الكردية من مناطق هذه الفصائل خوفاً من تجنيد بناتهن. وتعرضت المقاتلات لدى أسرِهن قبل الأطراف المقابلة للقتل أو كافة أنواع الانتهاكات، كما جند النظام النساء ولو بأعداد محدودة، ولأغراض إعلامية أكثر منها قتالية.
ـ العنف القانوني: تعاني النساء من القوانين الجائرة الموجودة أصلا والمتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الجنسية الذي يحرم الأم السورية وأطفالها من حق منح جنسيتها لهم، ولايتمكن بعضهن من الحصول على أوراق ثبوتية لهن أو لأولادهن تسوي أوضاعهن القانونية أو أوضاع أطفالهن في حالات الترمل أو الهجر أو الطلاق أو اختفاء الزوج، أو ولادة طفل دون زواج مثبت. يضاف إلى ذلك فقدان الأوراق الثبوتية، وفقدان حقوق الملكية.
ـ تتعرض النساء للاختطاف من قبل الأطراف المتنازعة بغية استخدامهن في عمليات مبادلة الأسرى أوالاتجار بهن، ولا يعرف تماما عدد المختفيات قسريًا في سوريا ولكن يقدر عددهن بالآلاف.
ـ تؤدي ظروف النزوح واللجوء إلى حرمان ملايين الأطفال السوريين من التعليم، وتحرم الفتيات خاصة منه بسبب خشية الأهالي من إرسال بناتهن إلى المدارس بسبب عدم أمان المناطق التي يسكنونها.
ـ العنف ضد الناشطات، عانت الناشطات السوريات من كافة أشكال العنف من اعتقال وتعذيب وتقييد ومنع سفر واستبعاد من أماكن صنع القرار، من قبل كافة الأطراف. كما تتعرض الناشطات النسويات إلى حملات تنمر وهجوم وتشهير.
ـ برز العنف الإلكتروني في السنوات الأخيرة سلاحا يستخدم ضد النساء وخاصة الناشطات منهن وذلك بغرض تهديدهن والحد من نشاطهن العام، والتشهير بهن.
كل ما وصف سابقاً يظهر صورة سوداء قاتمة لوضع النساء السوريات في السنوات العشرة الأخيرة، بعد أن قامت ثورة الحرية والكرامة وتحولت فيما بعد إلى نزاع مسلح تدخلت فيه قوى إقليمة ودولية، بحيث قسمت سوريا إلى عدة مناطق نفوذ تسيطر عليها إضافة إلى النظام سلطات أمر واقع وقوى احتلال عديدة.
تقع اليوم على عاتق منظمات المدتمع المدني، وهي منظمات حديثة العهد بالنشوء ضعيفة القدرات والموارد، مسألة حماية النساء ضحايا العنف بأشكالة كافة في جميع المناطق السورية، في ظل استمرار الاعتراف الدولي بالنظام السوري كسلطة شرعية، وتغاضيه عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، وتقاعسه عن دعم المنظمات بل تضييقه عليها، وتمريره المساعدات إلى النظام، الذي يعرف تماما أنه لن يوصلها إلى مستحقيها.
مالذي نفعله؟ سؤال يدور في ذهن كل من نذر/ت نفسه/ا خدمة لشعبه/ا وقضيته/ا.
هنا لابد من أن نفكر، كناشطات نسويات، بخطوات عملية يمكن أن نقدم بها ما استطعنا من جهود لحماية النساء ودعمهن وتمكينهنّ، ولدعم المعنفات والناجيات من العنف.
ـ الخطوة الأولى والأساسية هي تحالف المنظمات النسوية مع بعضها لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والاتفاق على أجندة عمل مشتركة، والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.
ـ القيام بدراسات وأبحاث تسبر الواقع وتقيم احتياجات النساء، وخاصة غير المتمكنات والمهددات بالعنف، تبنى على أساسها الخطط والبرامج والمشاريع، وإصدار كتيبات توضيحية مبسطة، توزع على أكبر عدد ممكن من النساء السوريات في جميع أماكن تجمعهن، تشرح آليات مناهضة العنف ضدهن، وإمكانيات التعامل مع حالات العنف، والوصول إلى الجهات المختصة، في كل دولة على حدة.
ـ خط ساخن تلجأ إليه المعنفة، يتم الرد عليه باللغة العربية، بالشمال السوري، ودول اللجوء القريبة، وحتى في الدول الأوربية، وتعميم هذا الرقم خاصة في تجمعات النازحين والللاجئين.
ـ مأوى للنساء المعنفات في جميع المناطق السورية والدول المجاورة، يتمتع بالشروط المعيارية اللازمة لتحقيق الأمن والرعاية والراحة للناجيات وأطفالهن.
ـ تأمين دعم نفسي اجتماعي صحي للناجيات، من قبل مختصات/ين مدربات/ين.
ـ تأمين بيئة آمنة للناجيات تشجعهن على الإدلاء بشهاداتهن أمام متخصصات/ين في هذا المجال، تراعي المعايير القانونية الدولية في توثيق الشهادات، تمهيداً لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات مستقبلاً.
ـ تمكين النساء، ولا يعني ذلك دورات خياطة وتطريز أو حلاقة أو ماشابه مما قامت به المنظمات النسوية سابقا من مشاريع سميت بمشاريع تمكين، وإنما تأهيل النساء لدخول سوق العمل إما بتدريبهن على حرفة يمكن أن تؤهلهن لكسب لقمة العيش، أو في اشتراط المنظمات العاملة في هذا المجال على الجهات الممولة أن يتبع التدريب قيام المنظمة بمشروع اقتصادي يعود بالنفع المادي على النساء (كالصنعات التقليدية أو الغذائية)، ومساعدة المتعلمات من النساء في الحصول على فرصة عمل.
ـ توعية مجتمعية بأهمية وضرورة مناهضة العنف ضد النساء، للوصول إلى مجتمع سليم معافى، تستهدف النساء والرجال معنا، وخاصة الفئة الشبابية، وتركز على أهمية تنشئة ورعاية الطفولة في جو خال من العنف والقمع.
ـ إيلاء رعاية واهتمام للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.
ولتحقيق ذلك لابد من القيام بخطوات أخرى على الصعيد الدولي:
ـ لايغيب بالتأكيد عن بالنا تقاعس المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم الأنظمة الاستبدادية، وعجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها الدولية، وخضوعها لإرادات الدول العظمى التي تلغي في سبيل مصالحها حقوق شعوب بأكملها، ما عطل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وإمكانية إحداث تغيير جذري ديمقراطي، يضمن الأمن والسلام للسوريين جميعهم، ويضمن عودتهم للعيش في ظل دولة ديمقراطية، دولة عدل وقانون، قائمة على أساس المواطنة المتساوية. لكن ذلك لا يمنع استمرار الضغط على المجتمع الدولي باتجاه تحمل مسؤولياته في ايقاف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريات والسوريين، والضغط باتجاه سلام وحلول عادلة. وهنا يمكن حالياَ تنظيم حملات مناصرة لقضايا السوريات والسوريين كالضغط على النظام لإيقاف حملاته ومجازره بحق المدنيين، وتغيير القوانين، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين، وحملات مناصرة لدعم مناهضة العنف ضد النساء في جميع المناطق السورية وبلدان اللجوء.
ـ السياسة لا تعني العمل فقط ضمن القنوات الأممية الرسمية التي أشبعتنا خذلاناَ، بل التوجه أيضا إلى القوى السياسية المناهضة للنظام الرأسمالي الذكوري العالمي المسيطر، من أحزاب ومنظمات مؤمنة بعدالة قضايا الشعوب المستضعفة والفئات المهمشة، لذا لا بد من القيام بحملات مناصرة تستهدف هذه الجهات.
ـ حملات مناصرة تستهدف المنظمات الدولية المهتمة بالشأن السوري، لدعم برامج ومشاريع مناهضة العنف ضد المرأة وتسهيل عمل المنظمات السورية العاملة في هذا المجال، وتدريب الكوادر العاملة في هذه المنظمات تدريباَ كافية يمكنهن/م من القيام بعملهن/م عند التعامل مع الناجيات أو عند نشر الوعي بمناهضة العنف ضد النساء.
ـ التعاون مع المنظمات النسوية والحقوقية الدولية بهدف مناصرة ودعم أجندة العمل المشتركة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
ـ السعي المستمر، ودعم المدافعات عن حقوق النساء، للوصول إلى مراكز صنع القرار في جميع المجالات، فهؤلاء من سيتمكن مستقبلاً من دعم كل جهود مناهضة العنف ضد المرأة.
ـ توظيف الإعلام بجميع أشكاله التقليدية والحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة التواصل بين المنظمات النسائية والنساء كافة، ودعمهن ونشر الوعي بقضايا النسوية والمساواة الجندرية ومناهضة العنف ضد النساء، والقيام بحملات دورية وطويلة الأمد تستهدف شرائح المجتمع كافة.
ـ التواصل مع منظمات المجتمع المدني المشرفة على التعليم في بعض المناطق والمخيمات، لإدخال ثقافة حقوق الإنسان والمساواة الجندرية ومناهضة العنف والسعي إلى العدالة والسلام في مناهج التعليم المعتمدة.