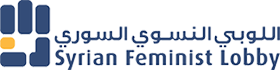نهى سويد
في زنزانةٍ رطبةٍ من زنزانات فرع فلسطين، اتخذت هاجر لنفسها زاويةً تبكي فيها بصمت لا يسمعه أحد إلا من جاورها في ضيق المكان. وفي إحدى الليالي استفقتُ على نحيبها. سألتها عمّا يُوجعها بعد كل ما نزل بها من إهانةٍ وضربٍ وتهديد، فقالت بصوتٍ خافتٍ منكسر:
“لستُ أخشى ما فعلوه بي، إنما أخشى ما سيقال عنّي إن خرجت.”
التعذيب والتحقيق لم يثن من إرادتها، وإنّما ما أوهن عزيمتها وأرعبها اتهام واحد، جهاد النكاح. حدثتني بصوت مرتجف: “إن خرجتُ، ستلازمني هذه التهمة كظلّي. ستلاحقني في الدوائر الرسمية وفي عيون الناس. في القانون يسمّونها دعارة، وفي الذاكرة الجمعية وصمة لا تُغتَفر”
على الضفّة الأخرى في الساحل السوري كانت ليلى ذات 17 عامًا تذهب كلّ صباح لمدرستها في اللاذقية، في يومٍ عادي تمامًا خرجت ولم تعد. اختُطفت ليلى…بحث أهلها لساعات، ثمّ أيّام، ثمّ صمتوا، بعد أسبوع ظهرت رواية جاهزة على إحدى القنوات ووسائل التواصل لتخبرنا بأنّ هذه الطفلة البريئة ابنة الأسرة العلويّة البسيطة، هربت مع عشيقها حيث كانت على علاقة به قبل أشهر، انتهى الأمر عند الناس، انتهت القصة قبل أن تبدأ، لم يعرف أحد حقيقة ما جرى لكنّ الجميع حفظ التهمة، مختصرين حياة الطفلة بجملة قيلت على عجل سرقت منها سمعتها، وإن عادت لأهلها ستعود مثقلة بما قيل عنها، لا بما حدث معها في الواقع.
من جديد، تُستخدم المرأة في دعايات السياسة وصراع النفوذ والمكاسب، تمامًا كما كانت في قديم الزمان أداة يُشرعن استعبادها باسم الوصاية والفضيلة. الفكرة ذاتها، وكما باتت في ظل نظام الأسد وسيلة لإذلال المجتمع وتطويعه، وكما تستعاد اليوم في سرديات السلطة الجديدة واتهاماتها الجاهزة وإن تغيّر الزمن وتبدّل الخطاب وتنوّعت المرجعيات الدينية والسياسية التي تستند إليها السلطة. فالآلية لم تتبدّل، ضرب الجماعة المختلفة من أضعف مواضعها، شرف النساء؛ وإخضاع المجتمع من أوسع أبوابه وصمة لا يقوى على ردّها وإن كانت كاذبة، لا تحتاج إلى دليل ولا إلى حقيقة كي تستقرّ في الوعي الجمعي. يختلف اللسان وتختلف الشعارات، لكن يبقى الاستغلال واحدًا، وتظل المرأة ومصيرها وحياتها ضحية معركة الصراع السياسي، ويُعاد تشكيل الخوف الاجتماعي بأقسى الطرق وأكثرها إذلالًا.
في الزنزانة نفسها تشاركت الحديث مع أمّ محمد، امرأةٌ سبعينية من ريف القنيطرة. سألتها عن تهمتها، أجابت ببراءة، وبساطة تؤلم سامعها:
“جهاد اللقاح يا بنتي هيك قالوا. ما أعرف شو هو.”
لم تكن تفهم المفردة، ولا من أين جاء بها المحقّق، ولا لأي غايةٍ صيغت.
أمّا مها ممرضة من إدلب، زوجة طبيب لا تنتمي لصفّ سياسي موالٍ أو معارض. بعد سيطرة الجيش الحر آنذاك على المنطقة التي يعمل بها زوجها، أصبح يهاب طريق العودة إلى منزله مخافة الاعتقال، فكانت هي تزوره. اعتُقِلت هي الأخرى بالتهمة ذاتها. كثيراتٌ مثلها اختُطِفن من الطرقات ومن الحواجز، لا أحد يعلم بمكانهنّ، وما إن يصلن المعتقل حتى تُلقى عليهنّ التهمة مسبقة الجاهزية (جهاد النكاح).
استثمر نظام الأسد بعد ثورة 2011 وما تلاها من تحوّلات وحربٍ هذه التهمة، وروّج لها كسلاح أخلاقي يُوجَّه ضد النساء المعارضات، أو المنتميات إلى البيئة الاجتماعية الحاضنة للثورة، حتّى دون أن يقمن بأي فعل سياسي. وسوّق في إعلامه أن الجماعات الإسلامية تجنّد النساء للخدمات الجنسية تحت غطاء ديني، لتوفير “رفاهية” للمقاتلين وتحسين شروط مقاومتهم. وكان المقصد الحقيقي تشويه الخصم، دينيًا وأخلاقيًا، عبر اتهامه بانتهاك شرف النساء المحسوبات عليه، لاستثارة مخيالٍ اجتماعي محافظ يرفض هذا السلوك ويرى فيه سقوطًا لا يُغتَفر.
لكنَّ الأكثر إيلامًا، لم يكن بطش السجّان ولا قسوة الجدران، بل تلك الفئة من السوريين الذين تلقفوا هذه التهمة الجاهزة وصدقوها بلا تردّد. جعلوا من إشاعة وضيعة مُبتذلة حقيقة قانونية ودليل إدانة. كان يكفي أن يخرج بيانٌ من شاشة الإخبارية السورية أو صحيفةٍ صفراء حتى تصبح المرأة متّهمة في نظر مجتمعٍ بأكمله، لا تحتاج المحكمة سوى رواية السلطة كي تحكم، أمّا الناس فكانوا يسارعون ليرفعوا أصابع الاتهام.
وما أبعد الأمس عن اليوم… وما أقربه في الوقت نفسه، إذ تعيد سلطة الشرع السيناريو ذاته بوجهٍ آخر، عبر إنكارها الممنهج لظاهرة خطف السوريات، وخصوصًا العلويات منهن.
تظهر السلطة على شاشاتها لتقول إنهن “هاجرن مع عشّاق” أو “تورّطن في أعمال مشبوهة”، فتسلب الضحية حقها في النجاة، وحقها في البراءة، وحقها في الحزن أيضًا. والموجع أن هناك من لا يزال يصدّق. من يتبنّى رواية السلطة كما هي، بلا مساءلة ولا شك، من ينكر حقيقة الخطف الممنهج، محوّلا الألم والغياب والخوف إلى تهمة وعارٍ يُعلّق على صدور النساء وحدهن.
مع اتساع موجات النزوح السوري وامتداد المخيمات في تركيا والأردن ولبنان، تجلّت أوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة الهشاشة، وضعت النساء والفتيات على نحو خاص في موقع قابل للاستغلال والابتزاز. وقد وثّقت منظمات حقوقية دولية عدداً من حالات التزويج القسري وبيع النساء أو مقايضتهن مقابل الغذاء أو المأوى، فيما عرف اصطلاحًا بـ “زواج الإطعام”، وهو نمط من العلاقات غير المتكافئة، يصنّف وفق معايير القانون الدولي كنوع من أنواع الاتجار بالبشر. كما أتاح غياب الحماية القانونية داخل المخيمات، وضعف الرقابة المؤسسية، لأقارب بعض الفتيات أو أفراد متنفذين من ممارسة هذا الاستغلال بلا رادع.
وتوازى ذلك مع تصاعد خطاب ديني متطرّف سعى إلى شرعنة هذه الممارسات، عبر استدعاء انتقائي لمفهوم تاريخي مثل “ملك اليمين”، وتوظيفه خارج سياقه الفقهي والتاريخي، بادعاء أن للرجال الحق في “امتلاك” النساء اللواتي لا معيل لهن مقابل النفقة والكسوة، وذهب بعض الشيوخ إلى حد الادعاء بجواز حيازة عدد كبير منهن دون عقد أو ضوابط.
شكّل مفهوما السبي وملك اليمين أبرز الأمثلة التاريخية التي صوّرت المرأة على إنها غنيمة. ففي الموروث الفقهي الإسلامي، جرى تقنين استعباد النساء في الحروب، ومنح الرجل حق امتلاك الأسيرة ومباشرتها جنسيًا دون عقد زواج. ورغم أن الزمن الحديث حقوقياً ومعرفياً، قد تعدّى هذه الممارسات والمفاهيم الداعمة لها، إلا أن غياب النقد الجذري لأصولها التشريعية أبقاها حاضرة في الخطاب الديني كجزء من “التراث المشروع”. والأخطر أنّ هذه النصوص تُستدعى عملياً كلما احتاجت الأيديولوجيا إلى تثبيت سلطة الرجل أو تبرير العنف، مستندة إلى شرعية تاريخية مكتسبة كأحقية إلهية، رغم أن هذا التوظيف النفعي يتعارض جوهريًا مع الفقه الإسلامي المعاصر ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات مكافحة الاتجار بالبشر.
وليس من المستغرب أن يتحوّل هذا التراث المشوّه إلى ذريعة لبعض العناصر المنفلتة والجماعات المنظمة، لتبرير اختطاف النساء السوريات المختلفات دينيًا، واعتبارهن سبايا يُباح امتلاكهن، كما شهدنا في خطف العلويات في مدن عدة، وفي اختطاف الدرزيات أثناء اجتياح السويداء. فالأدوات التاريخية نفسها، حين تُستدعى في زمن الصراع المعاصر تغدو سيفًا على رقاب النساء، يمتهن كرامتهن وحياتهن تحت غطاء شرعي زائف.
لا عجب أن تتنكر السلطة الجديدة ذات المرجعية الجهادية المعروفة لمسألة اختطاف النساء، وان تجعل منهن جناة ملقية عليهنّ التهم الأخلاقية، لتشرعن ممارسة الخطف بدل أن تُردعه بقوانين صارمة وحامية للنساء، وكأن هذه السلطة ومن يقودها، تثأر بطريقة ما لما ارتكبه نظام الأسد باسم الطائفة العلوية، مع أن العلويين أنفسهم كانوا من أكثر المتضررين من حكمه. فهل تمارس سلطة دمشق اليوم فعلًا انتقاميًا من الطائفة العلوية، عبر استباحة نسائها، أو واستخدام المُختطفات الدرزيات كورقة ضغط سياسية للنيل من كرامة المكوّن الدرزي؟ فالنظام السابق اعتقل أغلب نساء الثورة من الطائفة السنّية ملقيا عليهن تهمة ” جهاد النكاح” ذي المرجعية عند المتطرّفين من الدواعش، بينما الإسلام الحقيقي براء من هذا التوظيف. واليوم تعيد سلطة الشرع ذاتها إنتاج نمط استغلالي مماثل، مع تغيّر الضحية والطائفة، وتشرعن جماعاتها التسلّط باسم نصوص دينية تُستغلّ بمعناها التاريخي لتثبيت الهيمنة والسيطرة.
منذ أيام، أطلقت كاتبة سوريّة مصطلح “نسويات القاعدة” في إشارة إلى دعم بعض النسويات السوريات لهذه السلطة ذات الخلفية الجهادية، السلطة نفسها التي تنتهك حقوق النساء وتضيّق عليهن، وتستعبدهن جنسيًا. هؤلاء النسويات انقلبن فجأة على مواقفهن، فعندما كانت ذات السلطة تحكم أدلب، كنّ يصدرن يوميًا بيانات واستنكارات، من أبسط المواقف إلى أعظمها، يعلو صوتهن بلا كلل ضد الانتهاكات الجهادية، ويجدن في ذلك دعمًا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وكان حضورهنّ علامة على مقاومة الانتهاك والدفاع عن النساء المستضعفات.
لكن مع انتقال السلطة إلى دمشق تغيّر كل شيء. أصبح صوتهن داعمًا مطلقًا للسلطة نفسها، هنّ إما مبررات ومتواطئات أم صامتات أمام الانتهاكات المستمرة بحق نساء من طوائف أخرى، ومنهن من تستغل موقعها الوظيفي لتبرر للسلطة حتّى تحظى بمزيد من الثقة لدى السلطة وجمهورها، إنّه لأمر مخيف ومهين لصورة المرأة السوريّة تاريخيّا أن تتحوّل المدافعات عن حقوق النساء من إعلاميات ومحاميات وسياسيات.. إلى قوّة رديفة لقوّة السلطة تساهم في تشتيت العدالة وإذلال النساء، يا له من إذلال مزدوج للمرأة السوريّة ويا له من خذلان.
يشبهن في بعض جوانبهن الاتحاد النسائي السابق الداعم لسلطة الأسد، لكن بصورة أكثر فظاعة ودناءة، إذ كرّسن وجودهن لدعم سلطة تُغلق الأبواب أمام المرأة، وتستبيح أجساد نساء أخريات، وتُهمّش مشاركتهن السياسية والاجتماعية في الوقت الذي يجب أن يكنّ فيه صمام أمان للحقوق والحريات.تبقى نساء سوريا شاهدات على جراحهن، مثقلات بعارٍ لم يكن لهن يدٌ فيه، محاصرات بصمتٍ شارك فيه القريب قبل البعيد، وستبقى أجسادهن مرايا لمعارك ذكوريّة، لم يخترنها ولم يكنّ يومًا شريكات فيها، ومع ذلك تحملن تبعاتها كاملة، يحملْن ذاكرتهن وثيقةً دامغة تثبت أنّ الكرامة الإنسانية يمكن أن تُستلب، حين يتواطأ الجميع على انتهاكها.