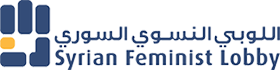علا الجاري
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، دخلت سوريا مرحلة انتقالية مضطربة، سرعان ما تحوّلت إلى ساحة جديدة للفوضى والعنف المنفلت، وبينما كانت آمال السوريات والسوريين معلّقة على بناء دولة قانون وعدالة، وجدت النساء خاصةً أنفسهن في قلب صراع جديد، تُستخدم فيه أجسادهن كأوراق ضغط ومساومة.
منذ شباط/فبراير ٢٠٢٥، بدأت التقارير تتحدث عن موجة من عمليات خطف استهدفت نساء علويات في مناطق التماس الطائفي الحساسة مثل حمص وريفها، ثم ريف حماة والساحل السوري، في سياقات انتقامية تغذيها نوازع طائفية ومصالح سياسية، تحوّلت فيها النساء إلى أدوات للابتزاز والهيمنة، وتصاعدت هذه العمليات في أعقاب المجازر الدامية، التي طالت أبناء وبنات الطائفة العلوية في الساحل السوري، مطلع آذار/مارس الماضي وحتى اليوم.
وفي تموز/يوليو بدأ فصل جديد من فصول الخطف، حيث شهدنا خطف نساء درزيات عقب اجتياح قوات السلطة الانتقالية والمليشيات الموالية لها محافظة السويداء الجنوبية، في تكرار لنمط استخدام المرأة وسيلة إخضاع ورسالة إذلال جماعي، وورقة تفاوض للضغط على الخصوم السياسيين.
لم يعد الخطف مجرد فعل جنائي معزول، بل أصبح استراتيجية سياسية تمارسها السلطة ضد مجتمعات معينة، تهدف إلى كسر النسيج الأهلي في هذه المجتمعات، وإعادة إنتاج الخوف في أكثر صوره عنفاً وإيلاماً.
يظهر تورط السلطة جلياً في تبنيها سياسة الإنكار والتعمية، إلى جانب التورط الفعلي لعناصر محسوبين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وحسب تقارير دولية تورط عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع في عمليات خطف واحتجاز أو تستروا عليها، في وقت تبنت فيه الأجهزة الرسمية والإعلام الرسمي خطاباً ينكر الجريمة، ويحمل الضحايا المسؤولية بدلاً من حمايتهن.
ويمكننا أن نعتبر في هذا السياق بيان وزارة الداخلية الصادر الأسبوع الماضي، وثيقة رسمية تدين السلطة الانتقالية وتفضح غرقها في وحل هذه الجريمة، فالتقرير عرض نتائج تحقيق أجرته لجنة مزعومة، مشكلة من الوازرة نفسها (المتهم أفراد منها بشكل مباشر بعمليات خطف)، بطريقة غير مهنية وغير قانونية تضع أي نتائج صادرة عنها موضع الشك، وخلصت هذه اللجنة إلى أنه بين ٤٢ حالة حققت فيها، هناك ٤١ حالة “غير حقيقة”، زاعمة أن النساء في هذه الحالات إما “هاربات مع شركاء عاطفيين أو متورطات في قضايا دعارة أو خلافات عائلية”، واعترفت بحالة واحدة فقط، أعيدت فيها الضحية إلى ذويها، دون الكشف عن هوية الجهة الخاطفة أو أي إجراءات محاسبة للجناة.
بهذا لم تكتف السلطة الانتقالية بالتقصير عن حماية النساء، بل تبنّت رواية تلوم الضحايا وتبرئ المجرمين، لتعيد إنتاج آليات التبرير القديمة التي استخدمها نظام بشار الأسد لتغطية الانتهاكات، من خلال التشكيك برواية الضحايا وعائلاتهن، وتمييع القضية عبر حملة إعلامية ممنهجة، تصبح أشرس كلما حاولت حقوقيات أو ناشطات رفع الصوت وإعادة تسليط الضوء على الجريمة المستمرة.
هذه الممارسات تكشف الهشاشة البنيوية في مؤسسات السلطة وأجهزتها، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع الجناة على التمادي، وتوظيف الجسد الأنثوي رمزاً في معركة السيطرة والهيمنة، خاصة في مجتمع محافظ كالمجتمع السوري، حيث تتجاوز آثار الخطف الأذى الجسدي والنفسي للضحية، وتمتد لتصبح وصمة اجتماعية، تطبع حياة الضحايا وعائلاتهن إلى الأبد، فالانتهاكات الجنسية التي تترافق عادة مع الخطف، تعد من المحرمات والتابوهات، وغالباً ما تُحمّل النساء مسؤولية الانتهاكات الواقعة عليهن، حتى عندما يكنّ ضحايا احتجاز أو عنف قسري.
لذلك نلاحظ أن الناجيات من الخطف لا يعدن مثقلات بأعباء جسدية ونفسية، وما يترافق معها من اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان الثقة بالنفس وإحساس الذنب والعار وحسب، بل يتضاعف الأذى الواقع عليهن عندما يستقبلن بالريبة والاتهام بدلاً من التعاطف والاحتواء.
تتحول الناجية في بعض الحالات إلى “مصدر عار”، وربما تمارس عليها ضغوط تدفعها للعزلة والقلق والخوف، أو قد تتعرض لمزيد من العنف بالتزويج القسري في سبيل “السترة” وإبعاد الوصم الاجتماعي، أو أسوأ ما نراه اليوم في سوريا وهو الصمت، والتخلي عن ملاحقة الجناة حفاظاً على سمعة العائلة أو خوفاً من تغول السلطة وأذاها، وهكذا تضاف جريمة اجتماعية إلى الجريمة الأصلية، وتتحول الضحية إلى منبوذة، فيما يظل المجرمون أحراراً، محميين بإنكار الدولة وصمت المجتمع.
وفي هذا السياق لا يمكننا تجاهل حقيقة أن أسر الضحايا في مثل هذه الانتهاكات، يعتبرون ضحايا ثانويين، قد يتعرضون جراء الوصم الاجتماعي لخسارات كبيرة أو قد يفقدون مصادر دخلهم أو مكانتهم الاجتماعية، فيجدون أنفسهم بين نارين: الرغبة في احتضان الضحية، والخوف من المجتمع.
الضغط النفسي والاجتماعي يحول الأسرة إلى بيئة هشة وغير آمنة للضحية بدل أن تكون حضنها الأول، في غياب دعم نفسي واجتماعي متخصص للأهل، ما يضاعف دوائر الألم، ويؤدي إلى تفكك المجتمع وامتداد الأذى إلى الأجيال التالية، عندما يعيش أطفال هذه العائلات في بيئة مشحونة بالقلق والعار والخوف، ليكبروا وينضموا إلى دوائر الصمت عن محاسبة الجناة وإدانة الضحايا.
لذلك عندما نفكر في تصميم أي برامج دعم للناجيات من الخطف أو الانتهاكات الجنسية، لا بد أن تتضمن استجابة فعالة تشمل عائلة الضحية في خطط التعافي، إذ لا يمكن أن نضمن شفاء المرأة وتمكينها، ما لم تشفى وتُمكّن الحاضنة الاجتماعية التي تعيش فيها، لتكون سندها في مواجهة قسوة العنف الواقع عليها.
تتجلى خطط الاستجابة الفعالة في خطوات عملية كجلسات التوعية والدعم النفسي الأسري للعائلة كاملة، حتى يتمكن أفرادها من تفريغ مشاعر الخزي والعار، إلى جانب الدعم الاقتصادي للأسر المتضررة، التي ربما كانت الناجية مصدر دخلها أو مصدر جزء هام من الدخل، ولا يقل أهمية دور الحملات الإعلامية لكسر الأنماط الاجتماعية التي تجرم الضحايا، إضافة إلى تأمين قنوات آمنة للتبليغ عن الانتهاكات، وإيجاد آلية فعالة للحماية القانونية والمحاسبة، مع ضمان خصوصية العائلات وعدم تعرضها للتشهير أو التكذيب.
مواجهة ظاهرة خطف النساء تحتاج أكثر من بيانات إدانة أو تحقيقات شكلية غير جادة، وتتطلب شجاعة سياسية واجتماعية لتحمل المسؤولية، فهذه ليست مجرد جريمة عادية ضد أفراد، بل انتهاك كبير لبنية مجتمع كامل، يُستغل فيه خوف العائلات وتتواطأ معه السلطة بحجة الاستقرار و”الطمأنة”، ليتحول الخطف من حدث فردي إلى أداة لإعادة إنتاج العنف، ولا يكسر هذه الدائرة إلا تمكين الضحايا وأسرهن للتعافي في فضاء آمن، أما المجتمع الذي لا يحتضن نساءه فلن يعرف الاستقرار، وسيظل جرحه مفتوحاً، ينزف في ذاكرة الأجيال التالية.