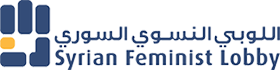إنانا حاتم : اسم مستعار لمعلمة من السويداء
سرتُ باتجاه الساحة الموعودة، كل ما أحمله قلب ينبض على إيقاع غير عادي وموسيقا تهدر بأوردتي، وكلمات لم تعد تفارق شفتي: ” يسقط الخوف … يسقط الخوف” !
لم أعلم سرّ تلك القوة التي انتابتني فجأة؛ شيء ما استيقظ داخلي كنت أظن آنه مات منذ زمن بعيد. تساءلتُ كثيرا عن سرّ الحماس الذي يجعل كل هؤلاء النساء يَسرنَ ليصبحن جزءاً من الحراك؟ ربما لأنها فرصتهن الوحيدة للتغيير.
أنا مثلهن، ركنت الكلام والتبريرات وتركت زوجي غارقاً في دهشته، مؤكدة أن بعض الأشياء لا تحتاج للشرح، فلقد تعبت أيدينا من نشر ملاءات الحزن، واقتلاع حشائش البؤس، تعبنا من مراوغة غول اليأس والجوع الذي ينهش القلوب والبيوت، ومن الكذب على أنفسنا، فلا عمل للأمهات في مطابخ تئن بالعوز، ولا مؤونة نرتبها لهذا الشتاء، تعبتُ من تصنع الابتسامة أمام أولادي الذين يتماهون مع الحزن والقهر واللاجدوى.
كل ما أعرفه أنني أحتاج أن أكون مع الجميع في الساحة لأقول كلمة:” كفى! “
أحتاج ان أذوب كقطرة ماء في ذلك المحيط علَّه يهدر بما خنقني لسنوات،أريد أن أصرخ بما علق في حنجرتي ولم يعد بالإمكان كتمه:” فأنا كائن أعيش على هذه الأرض وأحتجّ على عيشة الذل والقمع والقسر والتهجير، أحتج على الظلم والقهر اليومي، أريد أن أستعيد فضائي المسلوب من هذه المدينة، وأن أثبت لنفسي أنّي أمتلك الشجاعة لفعل ذلك: “.. ح … حر …حرية …حرية”.
هذه الكلمات باتت أقرب الآن، ها هي تعبُر قلبي، ثم تصعد لحنجرتي، لم أعلم سرّ ما يجري في داخلي، لكن ذلك الصوت لامس وجداني، أمسك بتلابيب ذاكرتي الضعيفة نافضاً عنها الخوف، فأعادها للوراء ثلاثين سنة، عندما كنت طالبة ثانوي، اظفر شعري بشرائط وردية، واسير لمدرستي وانا أغني “… يا بحرية هيلا هيلا … ،عندما أصل لمقطع ” يا حرية هيلا هيلا، أخفض صوتي “، يومها لآول مرة آصرخ ” حرية” مع رفيقات مدرستي احتجاجا على مدير مدرستنا وأوامره العسكرية
طفنا شوارع بلدتنا الصغيرة ونحن نصرخ : ” حرية…حرية “، انضم الينا الكثير من المرهقين، نادينا بعلو أصواتنا، امطرت السماد يومها فرحاً وسحراً غمرنا جميعاً قبل أن تغدر بفرحنا عصيهم وهراواتهم، لتلاحقنا تهديداتهم لسنوات بعد ذلك.
منذ ذلك اليوم نجحوا بحذف كلمة حرية من قاموسي، وكبلوا الجدران والشوارع فأغرقوها بصور ولافتات لشعارات جعلت أحلامنا تذوي.
سرت نحو الساحة وأنا أقول: “لازم هالمرة ننجح لازم نكمل؛ لا وقت الآن للحزن ولاستعادة الذكريات، لا وقت للراحة … أي …هالمرة غير …!”
أليس ما عشناه ونعيشه كافياً ليخرجنا جميعاً عن صمتنا؟ لم يحن الوقت لنصرخ؟ أن نحتجّ؟ أن نقول أننا تعبنا من العيش في هذا المنفى اغير الإنساني الذي نسميه وطناً.
“…لا أريد أن يبتعد أولادي عني، ولا أريد أن يعيشوا محرومين من الحرية، لا أريد أن يعيشوا مخنوقين بخوفهم، لا أريد .. لا أريد …” ، أصرخ في داخلي طوال الوقت.
أكملت سيري إلى أن وصلت السّاحة فاستقبلني أحد اليافعين عارضاً أمامي لافتات ولوحات عدة وطلب مني أن أختار إحداها، لفتني العدد الكبير للأطفال واليافعين في الساحة، حضروا مع آبائهم أو أمهاتهم، بعضهم كان يمسك بيد جده أو جدته، كانت الساحة تعج بكل الفئات العمرية وكل الأطياف وكأنه كرنفال.
الأطفال الأصغر سناً في حالة يقظة تامة للرد على الهتاف مع الجميع، وكأنهم كانوا جاهزين لهذه اللحظة منذ أن ولدوا.
أما الشباب فكان لهم الحصة الأكبر من الحضور، وقد ملاؤوا الساحة بالحياة، يبدو أن الأمل أضاء أمامهم من جديد في إيجاد فرصة الفرصة للحياة بالقرب من أهاليهم، بعد أن ضاقت أمامهم كل الطرق.
اقتربَت أكثر لأكتشف أن هناك جيش من المتطوعين الشباب جاهز للعمل ولحماية هذا الاحتجاج السلمي، البعض ينسق لطريقة الوقوف ولاستقبال المحتجين القادمين من القرى للإنضمام إليهم، والبعض يراقب أطراف المكان كي لا يفاجئهم أحد بأي ردة فعل يعرض التجمع للخطر.
الجميع كانوا حريصين على ترك الحافة الإسمنتية لكبار السنّ كي يجلسوا عليها عندما يتعبون من الوقوف، وفي عمق المكان افترش بعض الرسامون الأرض وتفرغوا لرسم اللوحات الكاريكاترية والرسوم المعبرة.
في الجهة المقابلة آلات موسيقية وبعض العازفين الشباب يتفننون في عرض أجمل ما قيل من أغاني شعبية وما غني من أغاني في الثورات وفي الساحات.
قسم من الشابات والشباب تخصص بترجمة كل ما كتب على اللافتات للغات الأجنبية حتى يصل صوتهم للعالم كله. كانوا يستطلعون آراء الشارع، ويهتمون بحرص بما ينقل على صفحات التواصل، ثم يكتبون ويختارون لليوم الثاني عبارات جديدة أكثر تأثيراً، عبارات بسيطة تحاكي وجع الناس وأحلامهم وآمالهم.
هذه الساحة تشبه الوطن رغم صغرها وقد اتسعت للجميع، فيها مكان وكواليس للتحضير والاحتفاء اليومي بالحياة الجديدة، أقسم الشبان ألا يتركوها، فكانوا يتناوبون على السهر فيها وهم يغنون ويعزفون للحرية. يبدو أن هؤلاء الشبان والشابات تعلموا درسا جيداً من السنوات الأخيرة وهم مصرّون على إنجاح مهمتهم، فالفشل هذه المرة سيكون بمثابة الحكم بالموت على جميع من دخل هذه الساحة.
أمسكَتُ اللافتة التي زينتها كلمة: “حرية للأبد ” ورفعتها عالياً وبدأت أصرخ بكلماتها، تمنيت أن أمتلك أكثر من حنجرة، أن أطوِّع الوقت وأوقف الزمن لأعجن اللحظات بنور تلك الإشراقة التي انبثقت من داخلي، أن أحملها وأزيّن بها الشوارع والحارات.
انا الآن مع الناس لأقول أن هذه البلاد التي نعاها العالم، وظنوا أنها أصبحت جثة هامدة لا زال فيها نبض، لا زال فيها حياة.